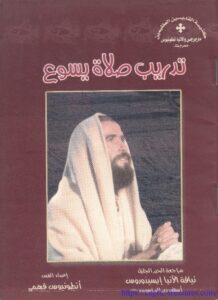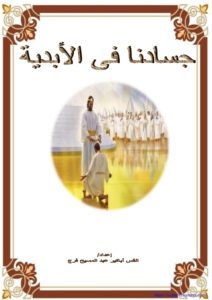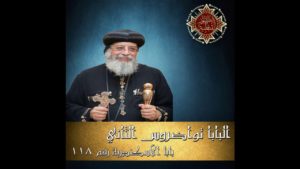كارت التعريف بالمقال
| البيانات | التفاصيل |
|---|---|
| إسم الكاتب | الراهب صليب الصموئيلي |
| السلاسل | سلسلة قصائد للراهب صليب الصموئيلي |
| التصنيفات | الحياة الروحية المسيحية - اللاهوت الروحي, تأملات روحية مجمعة |
| آخر تحديث | 14 أبريل 2020 |
هذه المقالة متاحة للقراءة فقط ولا يوجد لها رابط تحميل.
الأبدية
ولما كان في الغد من أمور لا يعلمها أحد, أثار فضول النفس كي تفكر فيما سيكون بعد أن تنتهي رحلتنا هنا... إلى أين سنرحل؟!!.
ذلك السؤال الذي عرف إجابته الشهداء فإستهانوا بالموت, والقديسين فتركوا كل متع العالم وزهدوا فيه, تائهين, غرباء, منتظرين ذلك اليوم الذي فيه تنحل كل رباطات الجسد والمادة منطلقين إلى.....
وهنا أصمت, إذ لم أكن أعرف ما عرفه أولئك الأبرار, حيث أني كنت قد إرتبطت بهذه الحياة وتلذذت بكل متع العالم, فصار الموت مخيفاً لي وكأنه أشد أعدائي إذ يفصلني عن تلك اللذة التي في الواقع لم أجد فيها فرحة دائمة ولكنها وقتية, وكثيراً ما كانت تعقبها أحزان وفراغ وإضطراب وجوع وعطش, وكأنها فرحة زائفة.
حقاً كما قال الكتاب المقدس: "النفس الجائعة كل مر حلو".
لقد شربت من مرارة العالم شاعراً بلدغاته داخلي وكنت أقول لنفسي لعل هذا من كثرة حلاوته, وهكذا عشت عبداً ذليلاً مخدوعاً لايعرف شئ عن الحقيقة إلى أن جاء ذلك اليوم الذي سمعت فيه حديث يتكلم عن السماء, ودار الحوار...
س: أي سماء تقصدون؟ هل في هذه السماء التي تسبح فيها الطيور سكان من البشر؟ وأين هم؟ ولما لا نراهم؟.
ج: هل أنت غريب عن هذه الأخبار الخاصة بالسماء وسكانها وملكوت الله العتيد أن يكون, وسكنى البشر مع الله إلى الأبد؟.
س: إني لمتحير في هذا الأمر, كيف يسكن الله مع البشر؟ وكيف يكون حال هؤلاء البشر؟ وهل هذا الأمر للجميع أم لفئة مختارة؟
ج: ولما هذه الحيرة أيها الأخ وهذه هى إرادة الله من البداية, فعندما خلق الله الإنسان أراد له التمتع بجميع ما خلق له, وبخاصة بعشرته معه, ولكن عندما أخطأ الإنسان وإستحال بقاءه في هذه العلاقة مع الله وعشرته, وذلك بسبب الحاجز الذي صنعه الإنسان بينه وبين الله بالخطية, أراد الله محب البشر أن ينقض هذا الحاجز المتوسط بينه وبين الإنسان بالصليب ليعيد هذه العلاقة, ليس فقط على الأرض كما كانت في البداية, وإنما أعد الله ملكوتاً سمائياً ليحيا فيه الإنسان معه إلى الأبد عائداً إلى تلك الحالة التي خلق عليها بل وأعظم منها أيضاً. لأنه إذ دفع بنفسه ثمن خطايانا, فتح لنا باب الفردوس السمائي, ذلك الذي كان قد أغلق على الأرض, وجعله لكل مؤمنيه, ومُريديه, ومنتظريه.
س: وهل يوجد من يعرف شيئاً عن هذا الملكوت؟ لأني متشوق أن أسمع عنه, أم صار الأمر مفاجأة للذين أعد لهم؟.
ج: إنه في الحقيقة مفاجأة ومكافأة, غير أن الله الذي لم يترك نفسه بلا شاهد, لم يتركنا بلا إرشاد, إذ كشف لنا ببعض المعرفة, وترك العقل يتأمل حالماً بما سوف يدركه, مشتاقاً إليه, وكأنه في سباق مع الزمن, متى سيصل؟!!!.
أما من جهة ما أتيح لنا معرفته عن الملكوت, فإنه يتلخص في ثلاث نقاط, ألاّ وهى:
المكان:
لست أدري أين المكان بالتحديد, ولا طريقة الوصول إليه, وإنما كل ما أعرفه أنه في السماء, وهكذا أشارت أيات كثيرة في الكتاب المقدس, منها على سبيل الذكر: "طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات" , "... لأن أجركم عظيم في السموات" , وأيضاً: "أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني..." (يو 24: 17) , ويقول الشهيد إسطفانوس الذي رأى السيد المسيح له كل المجد: "ها أنا أنظر السموات مفتوحة وابن الإنسان قائماً عن يمين الله" (أع 56: 7) , ويقول القديس يوحنا الحبيب: "نظرت وإذا باب مفتوح في السماء" (رؤ 1: 4) , ويقول أيضاً: "رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله" (رؤ 2: 21).
وبلا أدنى شك حينما نرفع أعيننا نحو السماء ناظرين في إشتياق إلى هذا الملكوت, إنما أيضاً نرتفع عن كل ما في الأرض إذ ليس لنا ههنا شئ باق.
وكما نرى في هذه السماء الحالة فوقنا من نعم وخيرات ترسلها إلى الأرض, فنجد الشمس والقمر والنجوم والكواكب والمجرات, والسحب المليئة بالأمطار, وصفاء لونها, وبديع جمالها في قوس قزح وأوجه القمر والكسوف والخسوف.
يا صديقي إن علمت بكل هذا الجمال في تلك السماء التي نراها بعيوننا, هذه التي تبهج النفس وتفرح القلب وتسمو بالعقل كي يحلق كالطيور مرتفعاً عن الأرض وملتمساً أن يلمس السحاب مقترباً من الكواكب والأجرام السمائية, فالملكوت كم وكم يكون؟!!!...
الزمان:
يقول الكتاب المقدس: "لكل شئ زمان, ولكل أمر تحت السموات وقت" (جا 1: 3) , أما في هذا الملكوت فالأمر يختلف, ذلك لأن الثوابت والوحدات الزمنية على الأرض سوف تبطل, فالثانية وحدة الدقيقة, والدقيقة وحدة الساعة, والساعة وحدة زمنية لقياس اليوم الذي يحدث نتيجة لدوران الأرض حول نفسها دورة كاملة واحدة, وبتعاقب الأيام يولد الأسبوع, والشهر, والعام الذي يحدث نتيجة لدوران الأرض حول الشمس دورة كاملة واحدة.
وهكذا يتضح لنا أن تحديد الزمن على الأرض قائم على أساس حركة الأرض حول نفسها, وحول الشمس, ومسار الكواكب والنجوم والمجرات والأقمار.
فإذا إنهار الأساس وإنتهى, ضاع معه كل ما بُنىَّ عليه. والكتاب المقدس يخبرنا أن السماء والأرض تزولان, والشمس تظلم, والقمر لا يعطي ضوء, وقوات السموات تتزعزع. فكيف إذن نحدد الزمن؟ , وبأي وحدة سوف يقاس الزمن في الملكوت؟ أم أن الملكوت هو حالة من الثبات الزمني؟ ولعل الزمن ليس موجوداً في سفر الحياة ولذلك لن يدخل إلى الملكوت.
ذلك الزمن الذي سيطر على الحياة في الأرض, فما تحدث حادثة على الأرض إلاّ وإرتبطت بالزمن, وكأنه سيداً ألزم الجميع للخضوع له دون إستثناء, حتى أنفاس الإنسان ودقات قلبه لم تعتق من هذه العبودية.
وكم كانت لحظات الفرح سريعة, وإلتمسناه أن يبطئ من حركته لعلنا نشبع من الفرح, ولكنه لم يسمع لنا. وهكذا أوقات الألم, وكم ترجيناه أن يسرع من حركته, فما أجاب. وكأنه يستشاط غضباً لفرحنا, ويتلذذ بآلامنا.
ياترى ماذا سيكون حال الإنسان بعد أن يتخلص من هذا السيد المسيطر, والذي قيد حتى المشاعر في الأعماق؟.
حقاً كيف تكون الحياة بدونه؟.
لاشك أن متعة الحياة في العتق من العبودية, والتحرر إلى حالة تفوق حدود الزمن...
وأما عن هذه الحالة التي عجز الزمن عن أن يدركها...
الحالة:
في الحقيقة لا توجد لغة أرضية مهما كانت قوية في ثرائها اللغوي وبديع جمال كلماتها, تستطيع أن تعبِّر عن هذه الحالة في الملكوت, كيف سنكون هناك؟!!!.
تلك الحالة التي تحيِّر في وصفها ذلك الحكيم والفليسوف, القديس بولس الرسول.
وأيضاً القديس يوحنا الحبيب الذي قيل له من قبل الرب: "فأكتب ما رأيت..." (رؤ 19: 1) , ولكن بأي لغة يستطيع أن يعبِّر عن كل هذا الجمال المبهر الذي يفوق إدراك البشر, لذلك أشار بإشارات ورموز, بمعاني وكلمات يستطيع العقل إدراكها وفهمها, ولكن ستظل الحقيقة كاملة مختومة إلى أن تعلن بالكمال في حينه.
إلاّ أن ما أتيح لنا من معرفة, ليس هو إلاّ تنسم رائحة الطيب, وليس الطيب ذاته.
دعني أجيز لك بعض نسيم هذه الرائحة لتعلم أن العقل يقف عاجزاً عن إدراك الطيب ذاته.....
... البداية هى لحظة فراق الأرض, وهذه متعة, نعم متعة لم يتمتع بها إلاّ من كشف الله عن أعينهم ورأوا السماء, فإشتاقوا إليها شاعرين بالغربة على الأرض, مشتهيين الموت إذ هو الجسر الذي يعبرون من خلاله إليها.
أو أولئك الذين عرفوا حقيقة الأرض, أنها لا شئ, حتى وإن ظهر لها جمال خارجي, من شهوة الجسد, وشهوة العيون, وتعاظم المعيشة, كل هذا لابد أن ينتهي, وكما قال سليمان الحكيم: "الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس" (جا 11: 2) , وهم إذ عرفوا حقيقة الداخل أنها عظام أموات وكل نجاسة, كشفوا حقيقة الأرض وكذبها وخداعها وإغواها لمن عليها بالتمتع بملذاتها, مُسكِره بلهوها وملاهيها عن حقيقة الموت, فرفضوها ونبذوها ملتمسين العتق من عبودية جاذبيتها, تلك الجاذبية التي سيطرت على الكل وربطتهم بها, مانعة كل من جال بفكره الإشتياق إلى السماء.
ومن هنا جاءت تلك المتعة التي تصاحب فراق الأرض.
ثم يليها متعة أخرى, وهى متعة فراق الجسد, ذلك الحِمل الثقيل الذي كثيراً ما أرهق الروح برغباته وشهواته, وكساتر منيع أحجب الكثير من طاقات الروح, تلك الطاقات التي أدرك بعضها من أخضع الجسد للروح وروَّضه.
حقاً أن للروح طاقات هائلة لكنها حبيسة داخل جدران الجسد, وكثيراً ما نخطئ القصد في الإهتمام تاركين السجين دون رعاية, معطين الأولوية للسجن بأساساته وجدرانه, فنزيدها علواً وإرتفاعاً وسمكاً, فيزداد السجن قوة, ويزداد السجين ضعفاً إلى أن يدركه الموت, ولذلك قال الكتاب المقدس: "لأن إهتمام الجسد هو موت, ولكن إهتمام الروح هو حياة وسلام" (رو 6: 8).
وهكذا صار الإثنين متحدي الهيئة والشكل, ولكن كل منهما في إتجاه مضاد, ملتصقين ولكن متنافري الميول. هذا من فوق يشتهي ما هو فوق, وذاك من التراب ينجذب إلى كل ما شابه طبيعته.
وكما قالت هذه الأبيات مُتخيِّله كلام صادر من الله إلى الروح فيقول:
+ قد حيــيت بك تــراب وأقمت بك هباء. + وقصدت أن تقــــوده, لا يقـودك للـــوباء. + قلت أنك في صراع وميول في عــــــــــــــــــــــــــــــداء. + لم أقل أنك في أرض سوف تحيا في هناء. + فالجسد نعمة ونقمة كيفــــما أنت تـشاء. + إن طلب شيئاً أجبته زاد طلباً في رجـــــاء. + وهو أبداً لا يـريد إلاّ أصلاً مــنه جــــــــــــــــــاء. + فالتــراب إذا رفعـته لا يحلق في الســـــماء. |
|---|
وكقول الرب: "أعداء الإنسان أهل بيته" , هكذا صارت عداوة بين الروح والجسد, فالعين التي لاتشبع من النظر وكل ما تراه تشتهيه, تعادي الروح التي تريد أن تكون عين مقفلة, والفكر الذي يبحر ويتوسع في معرفته لأي شئ, يعادي الروح التي تريد أن يكون لها فقط فكر المسيح, بل وهذا الجسد ببنيانه وقدراته وجماله, يعادي الروح التي تثق في الرب أنه هو قوتها, وجمالها, وكل ما لها.
ودعني أسألك....
هل رأيت في حياتك صاحباً وعدواً لك في نفس الوقت؟!!.
حتى أن القديس بولس الرسول يقول: "ويحي أنا الإنسان الشقي, من ينقذني من جسد هذا الموت؟".
وبما أن الخلاص من أعدائنا المقاومين لنا له متعته وفرحته, لذلك فإني متيقن أن الروح حينما تفارق الجسد تشكر الله مسبحه ومهلله لعمله قائله: "ليبتهج قلبي بخلاصك".
ثم بعد هذا يحدث شيئاً لم تراه من قبل, ولا أظن أنه قد خطر ببالك, أو حتى عبر على عقلك كمجرد حلم أو خيال.
إنها روحك... ماذا يكون شكلها؟ , ومن أي طبيعة هى؟ , وكيف تكون قدراتها وإمكانياتها, وعلم المعرفة الذي يحيط بها؟... لاشك أنها حالة من السمو عن عالم الأجساد, إذ تتلاشى عنها تلك الغشاوة التي لازمتها طيلة حبسها داخل جدران الجسد, وحينئذ ترى عالم الأرواح إذ صارت في الطبيعة مثلهم, كقول الرب: "يكونون كملائكة الله" , وهنا يحدث أول لقاء لها مع الأرواح (الملائكة).
وأود أن أقف لحظات متأملاً في هذا اللقاء...
هل رأيت ملاك من قبل؟ , وكيف يكون حالك وأنت في صحبة ملائكة؟... لابد أنها حالة من الفرحة والإبتهاج لم تشعر بها من قبل, محاطة بمهابة ووقار, وممتزجة بالسلام والطمأنينة.
ثم تمضيا معاً في رحلة إلى السماء, وأما عن هذه الرحلة فلا أعلم ما تستغرقه من الوقت, وبأي لغة سوف يتكلم معك الملاك إذا تكلم... الله يعلم.
وتصل إلى باب الفردوس الذي تجد عليه ملاك معه سفر الحياة, مدوَّن فيه أسماء من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة, وكلاً في رتبته, الشهداء, المعترفين, القديسين, الرهبان والبتوليين, الخدام, التائبين, المجاهدين.
ويا لفرحتك حينما تجد اسمك في سفر الحياة, ولأي رتبة أنت تنتمي, كطالب بعد مجهود عام كامل يرى نتيجته فيفرح بنجاحه, ولكن مع إختلاف الفارق في كم الفرح وكيفيته وديمومته.
ثم يستقبلك الملاك الحارس لباب الفردوس بالترحاب والبشاشة, ويأذن لك بالدخول...
فماذا ترى في الفردوس الذي ما هو إلاّ مكان إنتظار للأبرار إلى المجئ الثاني للرب يسوع المسيح؟
في الفردوس...
لا أستطيع أن أعبر لك عن مدى الفرح الذي ستمتلئ به دون أن ينقص, بل هو في تجدد وديمومة لا تنقطع, وذلك بمجرد دخولك إلى هذا المكان, وهذا لأسباب كثيرة أذكر لك منها:
العودة إلى الوطن الحقيقي:
فنحن نحيا في غربة, غربة مكان إذ ليس لنا ههنا مدينة باقية. وغربة صحبة وخيلَّان إذ إننا عندما تأملنا عن اليمين وأبصرنا, فلم يكن من يعرفنا وليس من يسأل عنا. وغربة تقلبات الزمان في الميول والأهواء, والإشتياق للسماء, والهروب من الأعداء, وأحزان وبكاء, كما قال الرب: "... لأنكم لستم من العالم بل أنا أخترتكم من العالم, لذلك يبغضكم العالم" (يو 19: 15).
وأما هناك فتجد راحة لم تجدها من قبل, ولا تعود تشعر بغربة مع من سبقوك إلى هناك, ولن يكون هناك تكبر أو تعالي من أحد عليك, أو غيرة وحسد لأنك زاحمتهم المكان. أبداً لن يكون...
صدقني أنك هناك سوف ترى الحب الذي لم تعرفه هنا على الأرض, ولكن لعلك قد تنسمت رائحته.
سوف تشعر بأنك في بيتك, كل من فيه أهلك وأحباؤك. لك دالة عندهم, وهم لهم دالة عندك. هم سيفرحون بمجيئك إليهم, وأنت سوف تفرح بصحبتهم وعشرتهم.
ولذلك من الأسباب التي تدعو إلى الفرح والبهجة...
وجودك مع أحباؤك:
حقاً إنك عندما تجلس بصحبة أصدقاء وأحباء لك, تتمنى أن لا يمر الوقت حتى لا تفارق من تحب, ويكون مجلسهم سبب فرح لك, هكذا يكون هناك...
ولعلك تسأل كيف سيعرفونني؟ , وكيف سأعرفهم؟.
لابد أن هناك لقاء تعارف مع الكل حتى لا يشعر أحد بغربة من أحد بل يكونون واحد كما قال الرب.
وكما لا يوجد عضو في جسدك لا تعرفه ولا تشعر به, هكذا يكون في السماء.
الكل واحد في محبتهم, في فرحهم, في موطنهم, حتى وإن كان هناك نجم يمتاز عن نجم في المجد, ومنازل كثيرة, وكلاً في رتبته, إلاّ أنه لن يوجد كبرياء من أحد, أو غيرة وحسد وحقد من أحد, تماماً كما لا ترتفع الرأس على الرجل لأنها تلمس الأرض, ولا تحقد الأذن على العين لأنها ليست في المقدمة مثلها, ولم نسمع قط إحتجاجاً من اليد اليمنى لأنها لا تتمنطق بساعة أو خاتم كما في اليد اليسرى.
ففي السماء سنكون شبه أواني كثيرة ومختلفة الأحجام ولكنها جميعها ممتلئة, فلن يشعر أحد بشئ ينقصه. الكل فرحان, سعيد, متهلل, مرتبط معاً بمحبة واحدة وروح واحد وفكر واحد, جسد واحد بأعضاء كثيرة له رأس واحد هو الله.
وهذا هو النور الحقيقي, والجوهر الحقيقي للفرح والبهجة التي نتمنطق بها.
الله ذاته...
الله ذاته:
هو السبب الحقيقي لكل الفرح والسلام والمحبة, وكل ثمار الروح التي سوف نحيا دائماً بها, إذ بدونه لا يوجد شئ, وبغيره لم يكن شئ.
وهذه هى الحقيقة... الله هو الملكوت, كل من يحيا معه وفيه وبه, يحيا في الملكوت حتى وإن كان لايزال على الأرض, ولذلك قال الرب: "ها ملكوت الله داخلكم".
وإذا تأملت قليلاً في العِشرة الإلهية مع الله, تجد كل ما سبق أن ذكرناه.
فمن جهة المكان:
الله لا يحده مكان, والسماء والأرض لا تسعانه, ولكن الرب علمنا أن نقول في الصلاة: "أبانا الذي في السموات..." , وذلك لتسمو أفكارنا وميولنا وإشتياقاتنا, وحينئذ نقول لله: "من لي ففي السماء ومعك لا أريد شيئاً على الأرض".
ومن جهة الزمان:
الله هو هو أمس واليوم وإلى الأبد, وألف سنة عند الرب كيوم, ويوم عند الرب كألف سنة, فلا يحده الزمان, ولا يؤثر فيه أو يغيِّره, لأن الله ليس عنده تغيير أو ظل دوران.
وأما من جهة الحالة:
الله روح هو, ولذلك قال القديس بولس الرسول: "فاذا نحن واثقون كل حين وعالمون اننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب لاننا بالايمان نسلك لا بالعيان. فنثق ونسر بالاولى ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب." (2كو 5: 6 - 8) , ويقول القديس أيوب البار: "وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله" (أي 26: 19). لأن الروح يفحص كل شئ حتى أعماق الله.
لذلك في الملكوت سوف يُغيِّر الله جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل إستطاعته.
ويقول الرب يسوع مخاطباً الآب: "ليكون الجميع واحد كما أنك أنت أيها الآب فيّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا" (يو 21: 17) , وهذا ما جعل الله يعد من يغلب قائلاً: "من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي, كما غلبت أنا أيضاً وجلست مع أبي في عرشه" (رؤ 22: 3).
وهنا يقف العقل عاجزاً عن الإدراك والفهم.
ترى كيف يكون هذا؟.
وما هى طبيعة وشكل هذه الوحدانية؟.
إنها حقاً سر الأبدية...